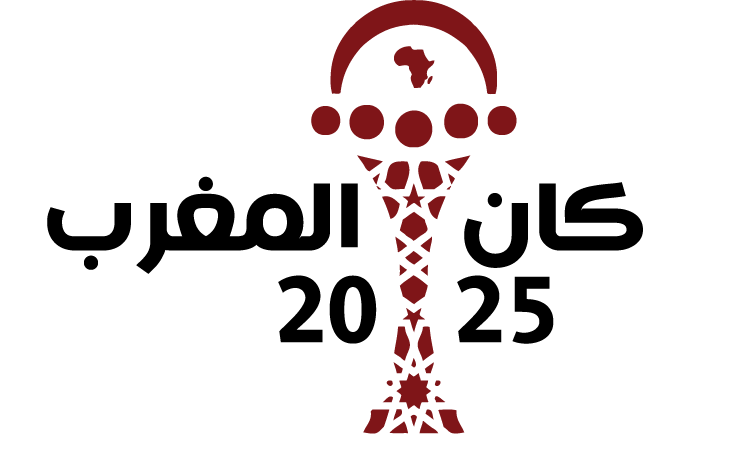«إلى روح سي محمد الخلفي… عم صباحا أيها الرجل الجميل، فقد ارتحت من غبائنا، ومن كل الضجيج!»
لا كرامة لفنان في وطنه.
ولو كان سي محمد الخلفي يعلم أيام المسرح الأولى أن الركح سينتهي به محمولا على نقالة تهرب به من المصحة، من أجل التقاط مزيد من الصور المحزنة له، لقال للطيب الصديقي، وبقية البقية: لا حاجة لي بمسرحكم المبكي هذا، ولا أريد أن أذهب في هذا المسار.
التقطت الصور كثيرا من الصور للرجل وهو في أرذل العمر، وقال لنا كل متصيدي الكليشيهات الكاذبة إنهم يعرفونه أفضل من الآخرين.
بقي الرجل هناك في مكان قصي من نفسه يشاهد بعين ساخرة باكية، عليه أولا، ثم على البقية، ما يقع.
لعله كان يقول في قرارة الأمارة بالسوء إن احتراف الفن في بلد، لازال غير قادر على النظر إلى الفنان نظرة سوية، أمر غير ذكي كثيرا.
لعله سخر من نفسه وهو يستوعب أنه التقط متأخرا جدا هذه الإشارة، وأنه لم يفهمها في الوقت المناسب.
ربما لو أتت التماعتها قبل هذا الزمن القاسي، كان سيختار حينها مهنة أخرى، أقل إيلاما، وأخف وطأ على النفس والروح من مهنة التعري الدائم أمام الناس هاته المسماة التشخيص.
مر الزمن على كل حال، وفعل أفاعيله، ورأينا، وشاهدنا، وسمعنا ما وقع لفنان كبير كان يفترض أن يعيش لحظاته الأخيرة في عزة وكرامة، وبعيدا عن أعين الفضول القبيحة، قريبا من ذكريات كل ما عاشه في الميدان من أمور، لن يرغب حين الوداع إلا في تذكر الجميل منها، ونسيان كل ما هو رديء.
لم نتح له جميعا هذه الفرصة.
فرضنا عليه حماقاتنا والرداءات.
وضعناه في ركن الحلبة الأكثر تعرضا للضرب، وتبادلنا أدوار القضاء عليه كل من موقعنا.
متى مات؟
متى أسلم الروح لبارئها؟
متى اقتنع أن البقاء معنا غير مجد كثيرا؟
في منزله؟ أن حين إخراجه من المصحة؟ أم حين نقله على عجل إلى المستشفى ثانية؟
لعله مات قبل يوم السبت بوقت طويل، حين انتبه أنه أصبح أسير النقالة ومختلف من يحملونها، ومن يحركونها، ومن يلتقطون قربها صور الإدانة لأنفسهم، ثم لوضع فني حزين، مؤلم، شاق على النفس، شقي حد فقدان القدرة على الحديث عنه بصدق لمن تبقى من الصادقين، وهم قليل.
يموت الفن المغربي في اليوم الواحد عشرات المرات، حين نضعه في الصف الأخير من الأولويات، وحين يردد التافهون منا والهاربون من المدارس إنه أمر نافل، ويتشدقون بأسنان بائسة بجملة الجهل القاتلة «آش خصك آلعريان؟ الفن آمرلاي».
يقنعون من لا يعرف، أي الأكثرية، أن الثقافة أمر غير مهم كثيرا، ويفتحون المجال لمن هب ودب لكي يعتدي عليها، ويقفلون الأبواب بالمقابل على الموهوبين الحقيقيين.
لذلك يموت فنانون كبار، وهم لا يجدون إلا إلزامية الخضوع لكليشيهات التصوير القبيحة المفروضة عليهم، من أجل رتق ثقوب اليومي التي لا تنتهي.
ولذلك أيضا لا يرتقي الفن كثيرا في الوطن إلى حدود الإبداع الحقة.
يبقى عالقا في مرحلة التنفس الاصطناعي، مضطرا كل مرة إلى الاستعانة بالأوكسيجين المصطنع قصد البقاء حيا، أو كالحي، وعندما تتعب قارورة الإنعاش من عملها، تتخلى عنه، فيموت.
ندفنه كما كل مرة، وهذه المرة أيضا، في مقبرة ما، ونتبارى في قول أشياء، أغلبنا لا يؤمن بها، ونفترق باحثين في الفن الأجنبي، شرقا وغربا، عن إبداع فعلي يروي الظمأ منا، دون أن يسأل أي واحد منا لا نفسه ولا الآخرين، عن سبب هذا القحط القاحل الذي يضرب المشهد الإبداعي عندنا، فيجعله فقط هكذا: بئيسا، حزينا، غير قادر على أي تميز فعلي.
لا نطرح السؤال لأننا نعرف جيدا الجواب، لكننا كعادتنا، نحن الشجعان المزيفون الخائفون من الحقيقة حد إنكارها، نفضل تحويل الأنظار، والتحديق في الاتجاه المعاكس، ملقين اللوم، كالعادة، على آخرين لا نراهم، ولا نريد أصلا منهم ولا لهم هذه الرؤية.
الله يرحم سي محمد الخلفي، مشهد وداعه الختامي مشهد حزين وأليم وجد قوي، ويصلح نهاية أو بداية لعرض جد واقعي، سيكون مرعبا وجد دال، إن وجد من يكتب ومن يخرج ومن يمثل، بشكل فني حقيقي هذا العرض غير المسلي نهائيا.