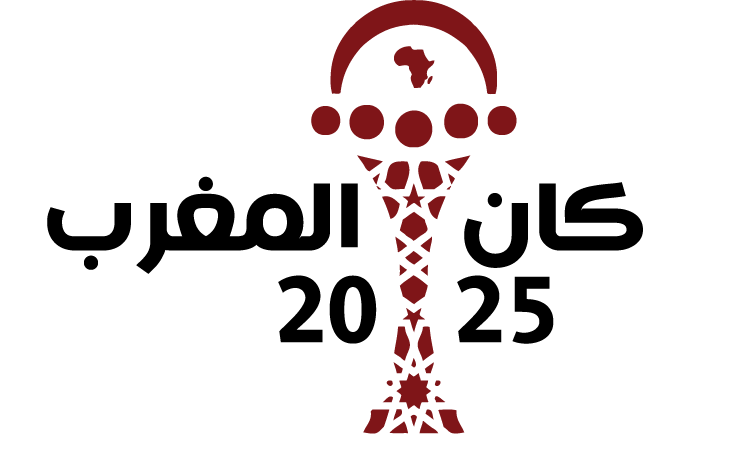* خلال تدبير عدد من الأزمات، لاحظنا انتقالا نوعيا من التدبير البعدي في أزمات سابقة إلى مقاربة استباقية في الفيضانات الأخيرة. هل يرتبط ذلك بنضج التجربة المغربية، أم بطبيعة الأزمات نفسها؟ وما هي العناصر والمؤسسات الكفيلة بإنجاح تدبير الأزمات؟
** لفهم هذا الانتقال نحو "المقاربة الاستباقية" يجب الانطلاق من قاعدة أساسية في علم تدبير المخاطر: الاستباق ليس قرارا إداريا فقط، بل هو أولا ممكن تقني– زمني مرتبط بطبيعة الخطر. بمعنى أن الدولة قد تمتلك إرادة قوية، ومؤسسات متطورة، لكنها لن تكون قادرة على الاستباق بنفس الدرجة في كل أنواع الكوارث. فالفيضانات، والسيول، والانجرافات المرتبطة بالتساقطات غير الاعتيادية تصنف غالبا ضمن المخاطر ذات التطور البطيء أو المتوسط؛ أي أنها تظهر "إشارات مبكرة" يمكن رصدها: نشرات إنذارية جوية، تشبع التربة، ارتفاع تدريجي لمنسوب الأودية، ضغط متزايد على السدود، تمدد رقعة المياه في بعض النقاط الحساسة… وهذه كلها مؤشرات تمنح صانع القرار "نافذة زمنية" للتصرف قبل بلوغ الذروة، عبر الإخلاء الوقائي، أو قطع بعض المسالك، أو تعزيز فرق التدخل، أو نشر معدات خاصة، أو رفع درجة التأهب في نقاط محددة.
أما الزلازل، فهي نموذج معاكس: خطر فجائي سريع، لا يتيح إنذارا زمنيا عمليا إلا في نطاق ثوان معدودة في أفضل الأحوال، ما يجعل "الاستباق" هنا لا يعني توقع لحظة الزلزال، بل يعني الاستعداد المسبق عبر كودات البناء، وتدعيم البنيات، والتخطيط الحضري، وأنظمة الاستجابة السريعة، والتمارين والمحاكاة. لذلك فجزء مما نراه اليوم من "استباق" في الفيضانات يعود فعلا إلى خصوصية الخطر الهيدرومناخي، وليس فقط إلى خيار إداري.
لكن هذا لا يلغي العامل الثاني، بل يؤكده: نضج التجربة المغربية خلال العقد الأخير. فالتراكم الذي حصل منذ 2015 مع دخول المغرب في منطق الالتزامات الدولية في الحد من مخاطر الكوارث، ثم اختبار الدولة بأزمات متتالية (كوفيد-19، الجفاف، الحرائق، زلزال الحوز، ثم الفيضانات) أنتج ثلاثة تحولات عميقة:
أولا، انتقال تدريجي من ثقافة "تدبير الحدث" إلى ثقافة "تدبير المخاطر"، أي من رد الفعل إلى بناء القدرة على التوقع والتخفيف. ثانيا، تطور منظومات اليقظة والتنسيق، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للمعطيات المناخية والهيدرولوجية والمراقبة الميدانية. وثالثا، تحسن واضح في التنسيق العملياتي بين الفاعلين، خصوصا عندما تصبح الأزمة واسعة وتحتاج إلى توحيد الجهد.
ومن هنا، فإن العناصر والمؤسسات الكفيلة بإنجاح تدبير الأزمات لا تختزل في مؤسسة واحدة، بل في منظومة متكاملة تشتغل قبل الأزمة وأثناءها وبعدها. قبل الأزمة، نحتاج إلى تقييم مخاطر دقيق (خرائط هشاشة، سيناريوهات، تحديد النقاط السوداء)، وإلى نظام إنذار مبكر متعدد المصادر، وإلى تخطيط للطوارئ قابل للتفعيل الفوري. أثناء الأزمة، نحتاج إلى قيادة واضحة وسلسلة قرار محددة، وغرف عمليات متعددة المستويات، وتنسيق لحظي بين القطاعات، وقدرة على تعبئة الموارد بسرعة، وتواصل موحد مع السكان. وبعد الأزمة، نحتاج إلى تقييم مؤسسي جدي، وإعادة بناء وفق مبدأ "إعادة البناء الأفضل" وليس مجرد ترميم ما تهدم، ثم إدماج الدروس المستخلصة في إصلاحات ملموسة.
أما على مستوى الفاعلين، فالقلب العملياتي عادة تقوده وزارة الداخلية عبر السلطات الترابية باعتبارها الضامن لوحدة القرار والقيادة الميدانية، بدور محوري للوقاية المدنية في الإنقاذ والإغاثة، وبمساندة القوات المسلحة الملكية في الكوارث الكبرى حين تتطلب القدرات الخاصة (إيواء، جسر جوي، مستشفيات ميدانية، لوجستيك ثقيل). كما لا يمكن فصل المنظومة عن القطاعات التقنية: التجهيز والنقل، الماء والسدود، الصحة، الطاقة، المياه والغابات، إضافة إلى الجماعات الترابية التي تمثل "خط الدفاع الأول" حين يتعلق الأمر بالوقاية المحلية والتدخل القريب.

* كيف تقيمون التجربة المغربية في تدبير الأزمات والكوارث؟ وما هي الآليات الكفيلة بالارتقاء بها إلى مستوى تجربة نموذجية؟
** عرفت التجربة المغربية في تدبير الأزمات والكوارث خلال العقد الأخير تحولا تدريجيا لكنه عميق، انتقلت فيه الدولة من منطق التدخل الظرفي المرتكز على رد الفعل إلى منطق أكثر تنظيما يقوم على التعبئة السريعة، وضبط القرار، وتحسين التنسيق الميداني في لحظات الضغط القصوى. وقد أبان هذا المسار عن قدرة معتبرة على احتواء عدد من الأزمات المعقدة، سواء من حيث تقليص الخسائر البشرية، أو الحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية الوظائف الحيوية، وهو ما يعكس تطورا حقيقيا في الأداء المؤسساتي والعملياتي.
ومن بين أبرز نقاط القوة التي كشفت عنها هذه التجربة، سرعة اتخاذ القرار في المستويات الحاسمة، والحضور المحوري للسلطات الترابية باعتبارها صلة الوصل بين التوجيه المركزي والواقع الميداني، إلى جانب الدور الحيوي للوقاية المدنية في عمليات الإنقاذ والإغاثة، والدعم اللوجستي والتنظيمي الذي توفره القوات المسلحة الملكية في الكوارث الكبرى التي تتجاوز القدرات العادية. هذه العناصر مجتمعة مكنت من رفع مستوى الجاهزية والنجاعة، ومنع انزلاق عدد من الأزمات إلى حالات انهيار شامل.
غير أن هذا التطور العملياتي يكتسب بعده الكامل عندما يدرج في سياق الإشراف الملكي المباشر على ملف تدبير الكوارث، باعتباره ملفا استراتيجيا يدخل ضمن صميم الأداء السيادي للدولة. فالتعامل مع الكوارث في الحالة المغربية لم يعد يختزل في كونه شأنا تقنيا أو قطاعيا، بل أصبح جزءا من رؤية عليا تؤطرها توجيهات ملكية واضحة تضع حماية الأرواح، واستقرار المجتمع، واستمرارية الدولة في صلب الأولويات. هذا الإشراف الملكي منح سياسات الوقاية، والاستجابة، وإعادة الإعمار طابعا استراتيجيا يضمن لها الاستمرارية، ويعزز منطق التنسيق والتعبئة الشاملة، ويسمح بتجاوز منطق التدخل الظرفي نحو بناء جاهزية دائمة.
كما أسهم في إدماج تدبير الكوارث ضمن منظومة الأمن القومي الشامل، حيث تفهم الكارثة باعتبارها اختبارا لقدرة الدولة على الصمود والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وليس فقط حدثا طب
يعيا عابرا.
* هل يعد التضامن الشعبي والعفوي عنصرا داعما لتدبير الأزمات أم عاملا قد يهدد نجاحه؟ ولماذا يبدو هذا التضامن أقل حضورا في الأزمة الحالية مقارنة بزلزال الحوز؟
** يعد التضامن الشعبي في السياق المغربي أحد أهم مكونات ما يعرف في أدبيات تدبير الكوارث بالصمود المجتمعي، أي قدرة المجتمع على امتصاص الصدمة، ومساندة الفئات المتضررة، والمساهمة في إعادة التوازن الاجتماعي بعد الأزمات. فالتكافل الاجتماعي، سواء عبر الدعم المادي أو المعنوي، أو عبر التطوع والمبادرات المحلية، يشكل رصيدا ثقافيا عميق الجذور، ويعزز الثقة بين المواطنين ومحيطهم الاجتماعي في لحظات الانكسار الجماعي. من هذه الزاوية، لا يمكن النظر إلى التضامن الشعبي إلا كقيمة إيجابية وعنصر قوة حقيقي في مواجهة الكوارث.
غير أن الممارسات الفضلى عالميا تظهر أن التضامن، إذا ترك دون تأطير، قد ينتج آثارا عكسية غير مقصودة. فالتدخلات العفوية، مهما كانت نواياها نبيلة، قد تربك سلاسل الإمداد، أو تحدث اختلالا في توزيع المساعدات، أو تخلق ضغطا لوجستيا إضافيا على المناطق المنكوبة، خصوصا عندما تتزامن مع عمليات إنقاذ حساسة. كما أن غياب التنسيق قد يؤدي إلى تكدس المساعدات في مناطق معينة مقابل حرمان مناطق أخرى أقل ظهورا إعلاميا، وهو ما يقوض مبدأ العدالة في الإغاثة. لذلك، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في التضامن ذاته، بل في كيفية إدماجه داخل منظومة تدبير الكارثة.

وفي ما يتعلق بالأزمة الحالية، يلاحظ أن مستوى التضامن الشعبي يبدو أقل كثافة مقارنة بما شهده زلزال الحوز، وهو أمر طبيعي ومفهوم ولا يعكس بأي حال تراجعا في روح التكافل لدى المجتمع. فالكارثة لا تزال في مرحلتها الحرجة، حيث تكون الأولوية المطلقة للتدخلات التقنية وعمليات الإنقاذ والإجلاء، ويكون أي اندفاع شعبي غير منظم قابلا لإرباك العمل الميداني، أو حتى تعريض المتطوعين أنفسهم للخطر. في هذه المرحلة، يميل المجتمع، بوعي أو بغير وعي، إلى ترك المجال للفاعلين المؤسساتيين المتخصصين.
غالبا ما يتخذ التضامن الشعبي زخمه الأكبر بعد استقرار الوضع الميداني، عندما تنتقل الأزمة من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الإغاثة والدعم الاجتماعي وإعادة التأهيل. ومن المرجح أن يتعزز هذا التضامن خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك، بما يحمله من قيم العطاء والتكافل. غير أن هذا التعزيز المنتظر ينبغي أن يواكب بتفكير استباقي من طرف السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل وضع آليات واضحة لتدبير التضامن نفسه، عبر قنوات رسمية للتبرع والتطوع، ولوائح حاجيات دقيقة ومحينة، واعتماد فاعلين جمعويين مؤهلين.
في هذا السياق، يصبح دور الدولة ليس في كبح التضامن، بل في تحويله من اندفاع عاطفي إلى مورد منظم يسهم في دعم التعافي، ويعزز الصمود المجتمعي، دون أن يتحول إلى عبء لوجستي أو مصدر تشويش على جهود التدخل. فالتضامن، حين يؤطر بشكل سليم، يتحول من رد فعل ظرفي إلى عنصر بنيوي في منظومة تدبير الكوارث.
** إن الارتقاء بهذه التجربة المغربية المعتبرة إلى مستوى نموذج مرجعي دوليا يقتضي انتقالا بنيويا أعمق من حيث الفلسفة العامة للتدبير، من منطق "إدارة الأزمة" إلى منطق "الحد من المخاطر". فالنموذجية لا تقاس فقط بسرعة التدخل أو بحجم الموارد المعبأة، بل بقدرة الدولة على تقليص الخسائر قبل وقوع الكارثة، وعلى إدماج الوقاية في التخطيط الترابي والعمراني، خاصة في المناطق الهشة والمعرضة تاريخيا للمخاطر.
ويفترض هذا التحول مأسسة التقييم البعدي لكل أزمة وربطه بإصلاحات ملموسة، وتعزيز قدرات الجماعات الترابية باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية، وتطوير حكامة المعطيات عبر منصات موحدة للمخاطر تدعم القرار الاستباقي، إضافة إلى الاستثمار المستمر في التكوين، والتمارين، والمحاكاة متعددة السيناريوهات. فالتجربة تصبح نموذجية عندما تتحول كل أزمة إلى فرصة لتقليص الهشاشة المستقبلية وبناء مناعة وطنية مستدامة، لا عندما تدار الأزمة بكفاءة ظرفية فقط.
نبذة
الدكتور المصطفى الرزرازي:
- باحث مبرز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
- أستاذ إدارة الأزمات بـكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية
- رئيس اللجنة العلمية لمركز "مصالحة"
- المدير التنفيذي للمرصد المغربي حول التطرف والعنف
- يرأس لجنة العمل الثانية الخاصة بالمقاتلين الأجانب والعائدين ضمن شبكة "إيميسا" في إطار برنامج مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي
- أستاذ محاضر بعدد من الجامعات اليابانية، من بينها سابورو غاكوين