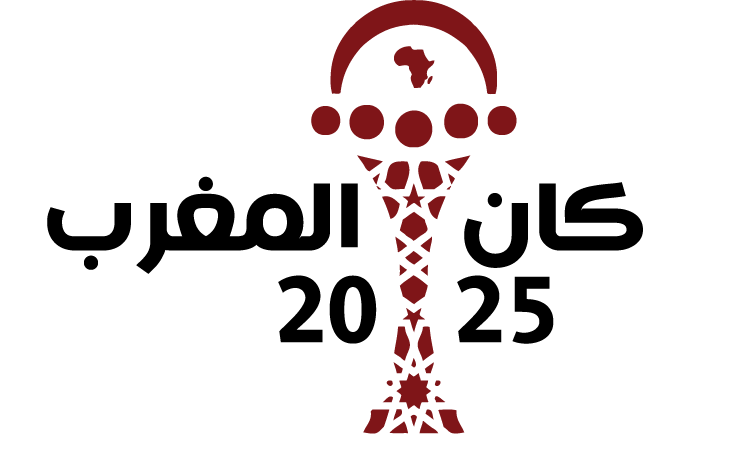حين يخطر ببالك أن تكتب بورتريها لعبد الهادي بلخياط، تدرك منذ السطر الأول أن الطريق لا يمرّ عبر حياته الشخصية، ولا عبر أسرارها الصغيرة، ولا عبر ما يُغري الصحافة من هوامش عابرة.. بل يفضي مباشرة إلى صوته.
كتابة بورتري عن عبد الهادي بلخياط لا يمكن أن تكون إلا امتدادًا لصدقه الفني. فالرجل لم يُغنِّ ليُقال عنه شيء خارج الأغنية، بل غنّى ليبقى الصوت هو الحكاية كلها. ولذلك، فإن القارئ العادي — مثلنا جميعًا — لا يهمّه أن يعرف تفاصيل أخرى عن حياته بقدر ما يهمّه أن يعود، مرة أخرى، إلى ذلك الصوت الذي كان ولا يزال الأعلى والأغلى في تاريخ الغناء والطرب المغربي. صوتٌ لا يُستمع إليه فقط، بل يُسكن، ويُورّث، ويُستعاد كلما احتجنا إلى معنى أصيل للفن.
لم يكن عبد الهادي بلخياط فنانًا يبحث عن الأضواء خارج صوته، ولا رجلًا يراكم الحكايات الهامشية ليُبرّر حضوره. لم يكن “نجمًا” بالمعنى الاستهلاكي للكلمة، ولا بلاي بوي، ولا باحثًا عن الانتفاع السريع، ولا جارٍ وراء مصالح شخصية تُستثمر ثم تُنسى. ولا مدمنا على صراعات ومختلقا لخصومات اعتاش ويعتاش منها الكثير من ادعياء الفن لأنهم غير قادرين على خلق ذواتهم / وجودهن خارج دوائر الحقد وشرارات الحروب الصغيرة.
استعادة عبد الهادي بلخياط، غداة رحيله، ليست تمرينَ رثاءٍ عابر، بل صلاةٌ كاملة في محراب صوتٍ كان أشبه بنا منّا. صوتٌ خرج من عمق التجربة المغربية، لا متعالياً عليها ولا متصنعاً لها، بل حاملاً تعبها، وشجنها، ورجفتها الداخلية. كان بلخياط يغني وكأنه يبوح باسم جماعي، وكأن حنجرته وُهِبت لتقول ما عجزنا نحن عن قوله، حين يثقل القلب ولا تسعف الكلمات. لذلك بدا رحيله أشبه بانطفاء مصباح داخلي، لا يُحدث ضجيجاً، لكنه يترك في الروح فراغاً بارداً، لا يملؤه إلا الصدى.
وبصوته ذاك، العميق والدافئ، صالحنا عبد الهادي بلخياط مع الحب في لغتنا اليومية، في دارجتنا البسيطة التي صارت، بفضله، لغة اعتراف نبيل لا خجل فيه. أغانيه جعلت أجيالاً كاملة تتجرأ على الغناء للحبيبات دون تكلف، ودون استعارة. «ما تاقش بيا»، «يا بنت الناس»، «هو اللي قلت له تا نبغيه»… لم تكن مجرد أغانٍ، بل جسوراً عاطفية، علّمتنا كيف نحب بصدق، وكيف نبوح دون ادعاء. كان بلخياط يغني الحب كما يُعاش، لا كما يُتخيل، ولذلك بقي صوته حيّاً فينا، نردده لا لأننا نُجيد الغناء، بل لأننا نُحسن الإصغاء لما يشبهنا.
شيءٌ كبيرٌ منّا، من ذلك الذي يجمعنا دون أن ننتبه، يسقط اليوم. يسقط بهدوء موجع، تاركًا فراغًا قد لا يُملأ أبدًا، لأن ما يُشبهنا حقًا لا يُعوَّض، بل يُفقد… ويُرثى.
نحن، المتَّهمين بلوثة النوستالجيا المؤلمة، وربما الغبية في نظر زمنٍ لا يُنصت، نعرف جيدًا أن هذا الحنين ليس ترفًا ولا هروبًا إلى الوراء، بل محاولة يائسة لحماية ذاكرتنا من واقعٍ غنائي لا يرقى إلى علوّ الأمس ولا إلى صدقه. ومنذ اليوم، سنغوص في هذا الحنين أكثر، علنًا، بلا اعتذار، لعلّنا نواسي به هذا الفقد العظيم، أو نخفف وطأة الغياب.
رحمك الله سي عبد الهادي… ولنا، نحن الذين بقينا، كل الصبر في هذا الركام العميم، نلتقط ما تبقّى من صوتٍ كان أعلى من الضجيج، وأصدق من الزمن.