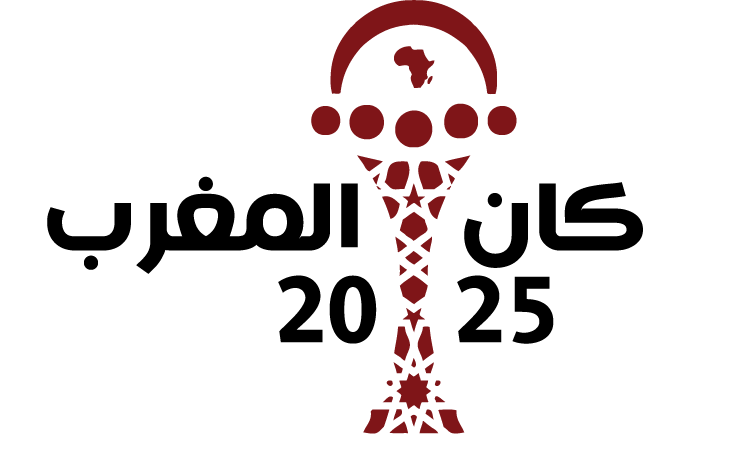لم تكن مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مجرد تسعين دقيقة من كرة القدم، كانت امتحانًا طويلًا للأعصاب، ومرآةً لذاكرة جماعية مثقلة بالانتظارات، وحكاية شعب تعلّم أن يفرح بحذر… لكنه حين يفرح، يفرح بكل قلبه.
وجهي بينهم… ووجوههم فيّ
أنا واحد من هذا الجمع. لا أكتب من مدرج الصحافة البارد، بل من مقعد القلب الساخن. من بيت مغربي يشبه آلاف البيوت، حيث تختلط الدعوات بالتحليل، والصمت بالتنهيد، والابتسامة بالخوف. عشنا الضغط منذ البداية. كنا متفائلين، نعم… لكن التفاؤل عند جيل الستينيات والسبعينيات ليس ساذجًا؛ هو تفاؤل جُرّب كثيرًا، وانكسر كثيرًا، ثم عاد يتشكل بصبر.
هذا الجيل يعرف معنى الانتكاسة، خصوصًا في كرة القدم. يعرف كيف تُبنى الأحلام، وكيف تُهدم أحيانًا بصفارة، أو تفصيل تحكيمي، أو لحظة غدر كروي. لذلك، ومع مرور دقائق البطولة، بدأ الإحساس بصعوبة الطريق يتسلل. كنا نؤمن بالمنتخب، لكننا نخشى التاريخ.
بيننا حديث قبل العاصفة
في الأيام التي سبقت المباراة، كان التواصل مستمرًا مع زملاء رياضيين تقاسموا معي هذا القلق الجميل. حديثي مع "جلول التويجر" و"منعم بلمقدم"لم يكن عابرًا. كان حديث ذاكرة، وحديث جيل. التفاؤل كان حاضرًا بقوة، لكن تحته قلق مشروع، كأننا نردد في سرّنا: اللهم لا تتركنا نعيد الألم نفسه.
حلقة أبكت المغاربة
قبل نصف النهائي، تأثرتُ بعمق بإحدى حلقات منعم بلمقدم عقب انتصارنا على الكاميرون في ربع النهائي. لم تكن حلقة تحليل تقني فقط، كانت اعترافًا إنسانيًا. حين عاد بذاكرته إلى 1988، إلى كأس إفريقيا التي نظمناها في بلادنا، إلى الهزيمة القاسية أمام الكاميرون، لم يتحدث كمحلل، بل كابن هذا الوطن.
تحدث عن الظلم التحكيمي، نعم… لكنه ذهب أبعد. تحدث عن والديه، عن الآباء والأمهات الذين انتظروا طويلاً لحظة فرح كاملة. بكى… وأبكى معه كل من تابع. في تلك اللحظة، كان منعم مهنيًا، وكان مغربيًا حتى الدموع. عبّر عن كل المغاربة الذين حملوا كرة القدم كأمل صغير وسط خيبات كبيرة.
ليلة الدعاء… ومباراة الأعصاب
أمس، قبل المباراة، لم نحلّل كثيرًا. دعونا. هذا الجيل يعرف أن بعض المباريات لا تُكسب بالخطة فقط، بل بالطمأنينة. مواجهة نيجيريا كانت صعبة، مضغوطة، ثقيلة. منتخب عنيد، تاريخ حاضر، وخصم لا يمنحك المساحة ولا الوقت.
الدقائق تمر ببطء. الأنفاس محبوسة. كل تمريرة محسوبة. كل هجمة نيجيرية تُعيدنا إلى ذاكرة قديمة، وكل تدخل مغربي يُعيدنا إلى الأمل. كنا نعيش المباراة بقلوبنا لا بأعيننا فقط.
حين انتصرنا… انتصر الوطن
وحين جاءت لحظة الفرج، لم يكن الانتصار تقنيًا فقط. كان نفسيًا، تاريخيًا، وجدانيًا. انتصرنا… وانتصر معنا كل المغاربة. في الشوارع، في البيوت، في المقاهي، في القرى البعيدة كما في المدن الكبيرة. أعلام، زغاريد، دموع، عناق غرباء يعرفون بعضهم دون أسماء.
كانت فرحة عمّت الوطن، لأنها لم تكن فرحة مباراة، بل فرحة استعادة الثقة. فرحة جيل قال: لم نُخلق لنخسر دائمًا. وفرحة شباب قال: نحن نكتب تاريخًا جديدًا.
وجوه لا تُنسى
في تلك الليلة، رأيت وجوهًا كثيرة:
– وجه الأب الذي صمت طويلًا ثم ابتسم.
– وجه الأم التي دعت بصوت خافت ثم زغردت.
– وجه الصحافي الذي نسي مهنيته لحظة، ليكون مغربيًا فقط.
– ووجهي أنا، بين كل هذه الوجوه، ممتنًا لكرة القدم لأنها منحتنا أخيرًا لحظة صدق.
خاتمة الحكاية المفتوحة
نصف النهائي لم يكن النهاية. لكنه كان تصالحًا مع الذاكرة، وجرحًا قديمًا بدأ يلتئم. اليوم، ونحن نكتب هذه السطور، ندرك أن المنتخب لم يمنحنا فوزًا فقط، بل أعاد لنا حقنا في الفرح الكامل.
وفي بلاد تعبت من الانتظار، يصبح الانتصار لحظة حياة… لا تُنسى.