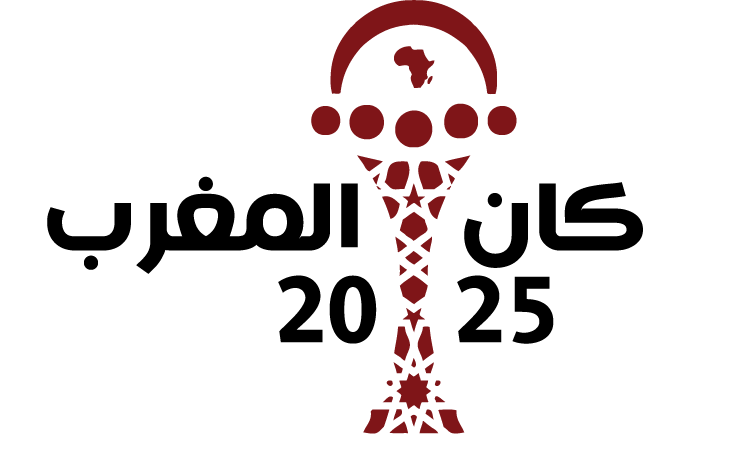* أمين عام رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية
يُعدّ موضوع دخول غير المسلمين النار من أكثر القضايا الدينية إثارة، ليس فقط على مستوى الخطاب الوعظي، بل في عمق الوعي الإسلامي نفسه، حيث يتقاطع الفهم العقدي مع الحس الأخلاقي، ويتواجه ظاهر بعض النصوص مع مقاصدها الكلية، ويُختبر تصور المسلم لعدل الله ورحمته اختبارًا حقيقيًا .
فالسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل كل من لم يؤمن بالإسلام، لمجرد عدم إسلامه، مصيره النار يوم القيامة؟ ومن هو “الكافر” في المفهوم القرآني والشرعي واللغوي؟ وهل مجرد “سماع” اسم الإسلام يكفي لقيام الحجة على الإنسان ؟ أم أن المسألة أعقد من هذا التبسيط السائد؟ .
لغويًا، الكفر في العربية لا يعني بالضرورة الإلحاد أو إنكار وجود الله، بل يدل في أصله على الستر والتغطية . ومنه سُمّي الفلاح كافرًا لأنه يكفر الحبوب بالتراب أي يغطيها ، وقد تحولت دلالة الكلمة لمن لم يؤمن بالله أي يغطي وينكر وجوده، ومازالت بعض المناطق الريفية العربية تُسمّى بالكفر مثل كفر الشيخ وكفر قاسم وكفر سوسه.
وفي هذا السياق يقول محمد مرتضى الزبيدي صاحب (تاج العروس) مضيفًا أن الكافر ذو كَفْر، أي ذو تغطية لقلبه بكفره، ولهذا كانت كلمة (الكافر) تقال لأي لابس سلاح، لأنه (يتغطى) بسلاحه .وكان العرب يطلقون اسم الكافر على الليل المظلم، لأن الليل “يستر بظلمته كل شيء”، ولهذا كان يُستعمل: “كفر الليل الشيء وكفر عليه” أي غطاه، وكان البحر نفسه يسمى الكافر لأنه يستر ما فيه ويخفيه.
هذا المعنى اللغوي العميق يفتح أفقًا دلاليًا مختلفًا: فالكفر ليس مجرد “عدم الانتماء” لدين ما، بل هو فعل قصدي يتضمن سترًا للحق بعد ظهوره ووضوحه . وهذا المعنى اللغوي انعكس بوضوح في الاستعمال القرآني، حيث لم يُستعمل لفظ الكفر استعمالًا تقنيًا سطحيًا، بل جاء مرتبطًا بالعناد والجحود والاستكبار ورفض الحق بعد تبينه، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ (سورة البقرة، الآية 89) .
ويقول ابن حزم رحمه الله في تعريف الكفر: “وهو في الدين صفة من جحد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معًا، أو عمل عملًا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان.” (الإحكام في أصول الأحكام، 1/45) .
القرآن نفسه يميز بين أصناف متعددة من غير المؤمنين، ولا يضعهم جميعًا في سلة واحدة,. فهو يتحدث عن المشرك المعاند، وعن أهل الكتاب، وعن المستضعفين، وعن من لم تبلغه الرسالة، وعن من ضلّ عن جهل، وعن من عاش في بيئة طُمست فيها الحقائق، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (سورة النساء، الآية99) .
هذا التعدد في الخطاب القرآني يدل على أن الحكم الأخروي ليس آليًا ولا ميكانيكيًا، بل مرتبط بدرجة المعرفة، وبنية القلب، وبالسياق الذي عاش فيه الإنسان . الإشكال الكبير في الخطاب الإسلامي المعاصر هو اختزال مفهوم “قيام الحجة” في مجرد سماع اسم الإسلام، أو رؤية مسلم، أو مشاهدة خبر عن الإسلام في وسائل الإعلام . وكأن الإسلام تحوّل إلى “إعلان تجاري”، من رآه فقد قامت عليه الحجة!
والحال أن القرآن يتحدث عن البلاغ المبين لا عن مجرد السماع المشوش، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (سورة الإسراء، الآية 15) . والبعث هنا ليس مجرد إرسال اسمي، بل تبليغ يُمكّن الإنسان من الفهم الحر، ويتيح له رؤية الحق في صورته الصافية لا المشوهة، كما قال تعالى: ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ﴾ (سورة الأنفال، الآية 42) . فكيف يُعقل، عقلًا وشرعا وعدلًا، أن يُحاسَب إنسان وُلد في قرية نائية في آسيا أو أمريكا اللاتينية، أو أدغال افريقيا ولم يعرف عن الإسلام إلا أنه دين عنف أو تطرف، بنفس معيار المحاسبة الذي يُحاسَب به من عاش في بيئة علمية اسلامية واطّلع على النصوص وناقش الحجج ثم اختار الرفض عن عناد؟ أي عدل هذا الذي يساوي بين من جحد بعد العلم، ومن جهل فلم يعلم؟ وقد قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (سورة فصلت، الآية 46) .
إن أكثر من نصف سكان العالم اليوم غير مسلمين، لا لأنهم “اختاروا الكفر” اختيارًا واعيًا، بل لأن الجغرافيا والتاريخ والثقافة حكمت عليهم بالولادة داخل منظومات دينية وثقافية معينة .
الإنسان لا يختار دينه عند الولادة، بل يرثه كما يرث لغته ولونه . فهل يُعقل أن تكون النجاة الأخروية مرهونة بصدفة الميلاد؟ وهل يتحول الله، حاشاه، إلى إله جغرافيا؟ . القرآن الكريم يرفض هذا المنطق رفضًا قاطعًا، ويؤكد أن الحساب فردي، وأن المسؤولية شخصية، وأن الله لا يظلم أحدًا، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (سورة المدثر، الآية 38) . ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (سورة النساء، الآية 40) . بل إن القرآن يفتح باب النجاة على أساس أوسع من مجرد الانتماء الشكلي، فيربط الفلاح بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورة البقرة، الآية 62)
.الفقه الإسلامي الكلاسيكي، في عمقه لا في تبسيطاته الدعوية، كان أكثر وعيًا بهذه الإشكالية، فقد تحدث العلماء عن “أهل الفترة”، وعن من لم تبلغه الدعوة أو بلغته مشوهة.. وفي هذا السياق يقول الإمام الغزالي رحمه الله: “أكثر النصارى والروم في هذا الزمان معذورون، لأن دعوة الإسلام لم تبلغهم إلا مشوهة.”
ويؤكد ابن القيم هذا المعنى حين يفرق بين من كفر عن علم ومن كفر عن جهل، ويقرر أن الحكم الأخروي لا يُبنى على الصور بل على الحقائق . أما الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر، فقد قال: "إن الله لا يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه قيامًا يزيل العذر، أما من لم تبلغه الدعوة صحيحة أو بلغته مشوهة فأمره إلى الله" .
إن المقاربة المقاصدية تُلزمنا بأن نفهم الإيمان باعتباره قيمة عدل وتزكية، لا مجرد شعار. وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (رواه البخاري ومسلم) .
ولهذا الخطر الحقيقي ليس في هذا السؤال الذي طرحناه أعلاه، بل في قمعه، لأن تحويل الدين إلى منظومة تُكفّر أغلب البشرية لا يُسيء فقط إلى صورة الإسلام، بل إلى مفهوم الله نفسه. مع أن الله في القرآن يقول: ﴿ولَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾(سورة الكهف، الآية 49) . ويقول : ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة الأعراف، الآية 156) . وليس من وظيفة المسلم أن يوزّع صكوك الجنة والنار، فقد قال النبي ﷺ: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم» (رواه مسلم) .
ختامًا، إن الله أعدل وأرحم وأحكم من أن يعذّب إنسانًا لم تقم عليه الحجة قيامًا حقيقيًا، ولم يختر الكفر عن عناد . أما من عرف الحق ثم جحده واستكبر عنه، فذلك شأن آخر. وبين هذين الطرفين مساحة واسعة لا يملك أحد أن يُغلقها إلا الله سبحانه وتعالى .
وهذا هو جوهر الإيمان الحقيقي: الثقة في عدل الله، لا في أحكامنا نحن، لأن البحث الصادق عن الحقيقة يقتضي الاعتراف بأن مسألة مصير غير المسلمين هي من الغيب الذي لا يُحسم بالشعارات، ولا يُختزل في فتاوى سريعة، بل يتطلب تواضعًا معرفيًا، وقراءة شاملة للنصوص، واستحضارًا لمقاصد الشريعة، وإيمانًا عميقًا بعدل الله الذي لا يُقاس بعقولنا القاصرة ولا بتصورات بعض الوعاظ .