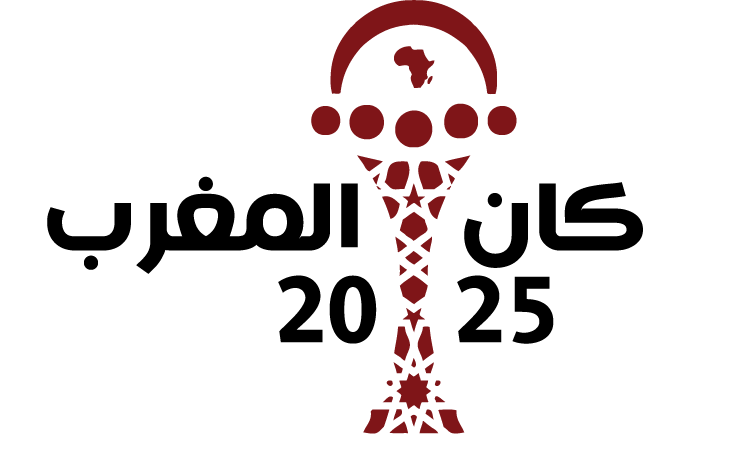تدخل مصر آمنا محملا بصور مسبقة، كما يفعل كل مسافر، ثم لا تلبث أن تفاجأ منذ اللحظة الأولى بأن الواقع أذكى من الخيال، صدمة إيجابية كاملة الأركان، تعرف بنفسك كمغربي، فلا تقابل بالتحفظ، بل بابتسامة تلقائية، وبجملة قصيرة تحمل أكثر مما تقول: "ديما مغرب"، هنا تبدأ الدهشة، لا أحد يختبرك، ولا أحد يضعك في خانة، بل يعاملك الناس كما لو كنت واحدا من أهل البيت، ضيفاً قديماً تأخر في الزيارة.
في الشارع، في المقهى، في سيارة الأجرة، وفي أبسط المعاملات اليومية، تكتشف أن هناك احتراما صامتا يسبقك، وأن اسم المغرب يفتح بابا من الود غير المتكلف، هذه ليست مجاملة سياحية ولا لباقة عابرة، بل شعور متجذر، كأن المصري لا يرى فيك "آخر"، بل امتدادا بعيدا لقصة يعرفها جيدا.
ليست مصر التي في خاطري بلدا نتابع شؤونه من بعيد، بل هي حالة وجدانية، ذاكرة مشتركة، ومرآة يرى فيها المغربي شيئا من نفسه، فمصر، بالنسبة للمغاربة، كانت دائماً مدرسة في الفن والمعنى، من السينما التي شكلت الوعي البصري لأجيال كاملة، إلى الأغنية التي عبرت البيوت والمقاهي والأسواق، لذلك ظلت مصر حاضرة في البيت المغربي كجزء من التربية غير المعلنة، وكركن ثابت في الذاكرة العاطفية، حتى لدى أجيال لم تطأ أقدامها أرضها يوما.
وإذا كان للتقارب المغربي-المصري اليوم جذور عاطفية عميقة، فإن أحد أهم روافده التاريخية يظل التأثير الفني المصري داخل البيوت المغربية نفسها، حيث تشكل وعي جيل كامل من المغاربة على المسلسلات المصرية التي كانت تجمع العائلة مساء، وعلى السينما التي قدمت نماذج للمدينة، للحب، للعدالة الاجتماعية، وللسخرية من السلطة، فصارت القاهرة حاضرة في الخيال اليومي للمغربي كما لو كانت مدينة يعرفها شخصيا، أغاني عبد الحليم حافظ وأم كلثوم لم تكن مجرد موسيقى، بل تربية ذوق وإحساس باللغة والمعنى، فيما صنعت أفلام عادل إمام ورفاقه وعيا نقديا لدى أجيال كاملة، تعلمت الضحك على القهر، وفهم التناقضات الاجتماعية من خلال الفن، بهذا المعنى، لم تكن مصر ضيفا على البيت المغربي، بل أحد مكوناته الرمزية، وجزئا من ذاكرته العاطفية التي ما تزال تفسر، إلى اليوم، ذلك الشعور الفوري بالألفة بين الشعبين.
اليوم، يتعزز هذا الترابط الثقافي بأدوات جديدة، المنصات الرقمية، وتنامي الاهتمام المتبادل بكرة القدم واللهجات، كلها عوامل تقرب المسافات وتكسر الصور النمطية، المغربي لم يعد غريبا عن المزاج المصري، هناك نوع من "الألفة المستعادة"، كأن البلدين يعيدان اكتشاف نفسيهما خارج ضجيج السياسة وتقلباتها.
في هذه اللحظة بالذات، لحظة التقارب الإنساني قبل السياسي، يعود الحديث عن العلاقات المغربية-المصرية محملا بدفء مختلف، قادم من الشارع، من الناس، من التفاعل اليومي البسيط الذي يتجاوز الحسابات الرسمية ويؤسس لاحترام متبادل آخذ في الترسخ.
خلال السنوات الأخيرة، بدا واضحا أن صورة المغرب في المخيال المصري تشهد تحولا إيجابيا لافتا، لم يعد المغرب بالنسبة لكثير من المصريين "بلدا بعيدا"، بل صار فضاء مألوفا، قريبا ثقافيا، ينظر إليه باعتباره نموذجاً في الاستقرار، وفي التوازن بين الأصالة والتحديث، وفي الحضور الهادئ الواثق في محيط إقليمي مضطرب، ولا يبدو التقارب المغربي-المصري مجرد موجة عاطفية عابرة، بل فرصة تاريخية ناضجة لكتابة سيناريو ذكي لشراكة تتجاوز البروتوكول، فالتفاهم الشعبي يمهد الطريق أمام القرار الرسمي، يصبح الاستثمار في هذه العلاقة استثمارا في المعنى قبل كل شيء، فهذا التقارب الشعبي الصامت قد يكون، في زمن الأزمات، هو الرأسمال الحقيقي الذي يعول عليه، فالعلاقات التي تسندها الذاكرة والثقافة والاحترام المتبادل، هي وحدها القادرة على الصمود.
لم يحدث هذا التقارب بين المغاربة والمصريين فجأة، بل تسلل بهدوء، ليعيد ترتيب الذاكرة على مهل، تعددت الأسباب، لكنها التقت عند نقطة واحدة: تعب الناس من الصور الجاهزة، ورغبتهم الصامتة في معرفة بعضهم بعضاً خارج منطق الوساطة والتهويل، لعب السفر دوره، حين اكتشف المصري في المغرب بلدا يشبهه أكثر مما كان يظن، مصريون زاروا المغرب فعادوا بانطباع عن مجتمع منفتح دون ضجيج، متدين دون تشدد، كما لعب الإعلام الجديد دوره حين فتح نوافذ غير خاضعة للمونتاج الرسمي، ولعب الواقع العربي المأزوم دوره أيضا، إذ جعل الاستقرار قيمة تحترم لا تحسد.
المثير في هذه العلاقة اليوم أنها غير متكافئة في الذاكرة، لكنها متوازنة في الشعور، فالمغربي يحمل مصر في داخله منذ زمن بعيد، فيما يكتشف المصري المغرب الآن بعين جديدة، بلا أحكام مسبقة، وبفضول إيجابي. وهنا تكمن قوة اللحظة الراهنة، نحن أمام علاقة لا تقوم على الحنين وحده، ولا على المصلحة وحدها، بل على إعادة اكتشاف متبادلة، تعيد ترتيب المكانة لا على أساس من سبق من، بل على أساس ما يمكن أن ينجز معا.
في النهاية، مصر التي في خاطري هي مصر القريبة من المغرب دون ضجيج، الحاضرة في وجدانه دون ادعاء، وهي في الوقت نفسه، صورة عن المغرب في عين المصري: بلد يُحترم، يُقدَّر، ويُنظر إليه باعتباره شريكا طبيعيا في الحلم المؤجل.